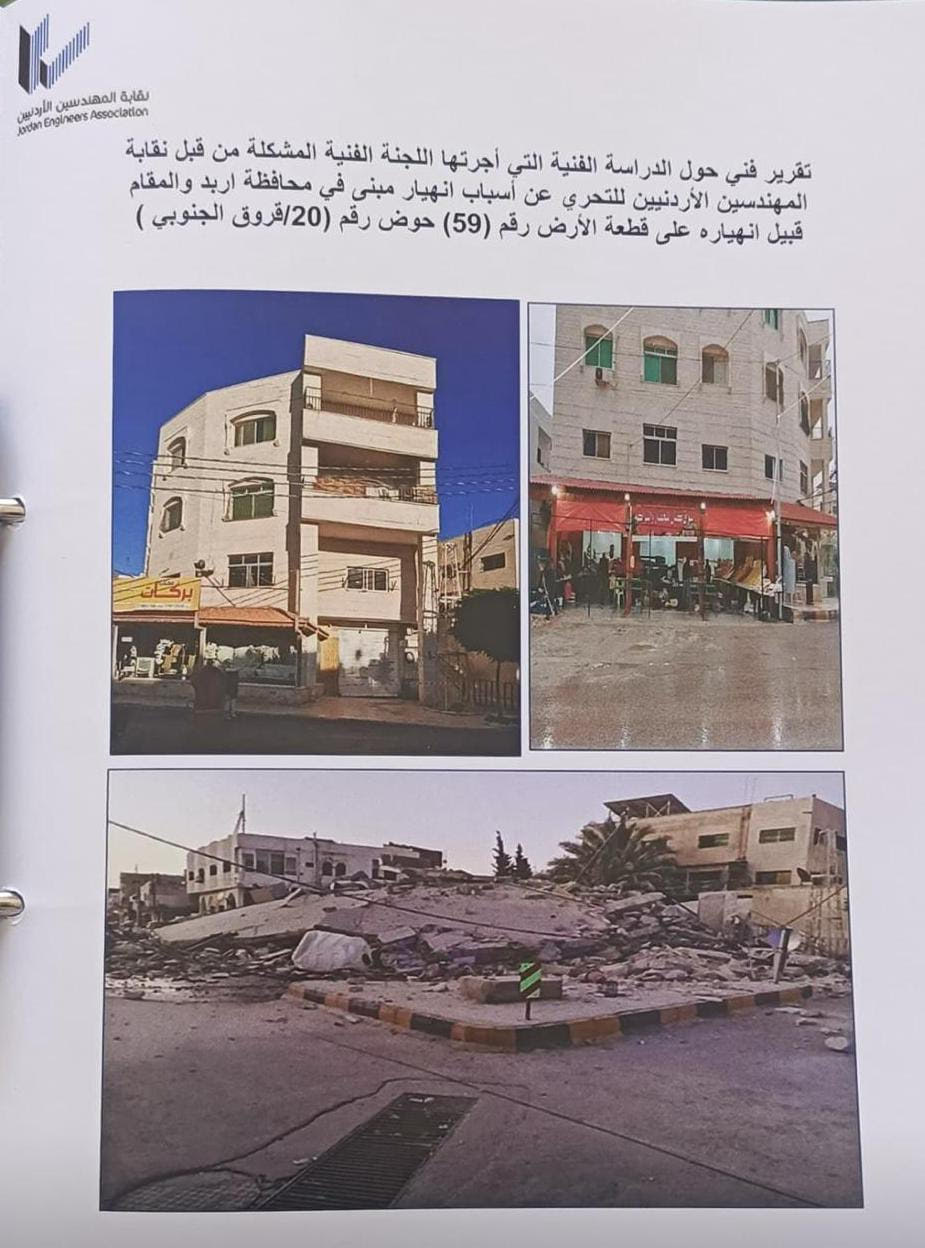لا أموي ولا علوي

سامح
قاسم.
ما
يحدث في سوريا ليس حربًا بين التاريخ وأشباحه، وليس ثأرًا مؤجلًا بين ظلال السيوف
في صفّين وكربلاء، ولا امتدادًا لصراعات منقوشة في ذاكرة الرمال والفرات. إن
محاولة إلباس المشهد عباءة الأمويين أو العباسيين، وتسميته بأسماء مذهبية مغرقة في
القِدم، ليس إلا تضليلًا يُبعد الرؤية عن أصل الجرح، ويُحيل الدم المسفوك إلى مجرد
سطر آخر في كتاب الفتنة الكبرى، دون أن يلتفت إلى الحقيقة الأكثر فداحة: أن ما
يحدث الآن هو لحظة جديدة من الانهيار، لحظة مكتملة بذاتها، وإن بدت امتدادًا لما
سبق.
حين
تُدكّ المدن بالبراميل المتفجرة، لا يسأل الركام عن مذهب ضحاياه. وحين يُلقى
بالأطفال جثثًا على الشواطئ أو في غياهب المعتقلات، لا تأتي أرواحهم إلى العالم
الآخر وهي تحمل كتب الفرق والملل، ولا تسأل الملائكة عن انتماءاتهم حين تكتب
أسماءهم في دفاتر الفقد الأبدي. وحين يجتمع العالم بأسره على صمت جريمته، لا يبحث
في أصول الضحايا ليتأكد إن كانوا من ورثة الأمويين أو من أحفاد الحسين.
إنها
حرب تُخاض بأدوات حديثة، لكنها تُلبّس نفسها رداء الطوائف والتاريخ، لا لأنها
كذلك، بل لأن الغرق في هذه الرواية يبررها، ويجعل منها معركة أزلية، كأنها قدر
محتوم، أو لعنة لا فكاك منها. لكن الحقيقة عارية وبسيطة وقاسية: إنها حرب سلطة،
حرب وجود، حرب تتكئ على الطوائف لا لأنها تعنيها، بل لأنها أسهل الطرق لتقسيم
الدماء إلى معسكرات، وجعل القتل مبررًا، والإبادة "ضرورة".
لقد
نجحت السلطة السابقة والسلطة الحالية في تحويل سوريا إلى مرآة مهشمة، يعكس كل كسر
فيها وجهًا مختلفًا للحرب. فهناك من يراها معركة دينية، وهناك من يراها صراعًا
جيوسياسيًا، وهناك من يراها انتقامًا تاريخيًا مؤجلًا. لكنها، في حقيقتها العميقة،
ليست حربًا بين السنة والشيعة، ولا بين أمويين متخيلين وعلويين مزعومين. إنها حرب
بين من يريد أن يبقى، ولو كان الثمن هو تحويل البلد إلى أرض خراب، ومن يريد أن
يولد من جديد، ولو كان الثمن هو العبور بين الجثث والمنافي.
لقد
أُلبست المأساة أسماء كثيرة، لكنها في جوهرها أبسط وأشد وحشية: إنها حرب السلطة ضد
الإنسان، وحرب المصالح ضد الحلم، وحرب الطغيان ضد كل ما تبقى من معنى للحرية.