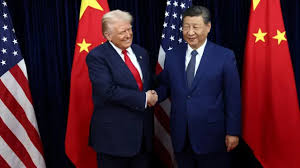مشاكل أميركا مع حلفائها: اسرائيل واوكرنيا نموذجا

ترجمة بتصرف انس ابو سمحان
مُقدّمة المُترجم:
يتناول الدبلوماسي
الأميركي السابق ريتشارد هاس في هذه المقالة مشاكل أميركا مع حلفائها وأصدقائها،
وكيفية تعاملها معهم منذ بداية عصر التفوق الأميركي العالمي عقب الحرب العالمية
الثانية. إلا أنه وفي مقالة في أكثر من 5000 كلمة يأتي على ذكر إسرائيل (في
المقالة الأصلية) 82 مرَّة مقارنة بحلفاء أميركا الآخرين (بريطانيا: 4 مرات،
فرنسا: 5 مرات، أوكرانيا: 20 مرة، تركيا: 8 مرات، باكستان: 13 مرة، الهند: 6 مرات،
تايوان: 6 مرات، فيتنام الجنوبية: 5 مرات.
كانت الأمثلة الأولى
كلها، في كل حالة، تشير إلى سلوك إسرائيلي قائم على معارضة الولايات المُتحدة
ومخالفة مصالحها الصريحة، بل وحتى تجنب الضغط الأميركي بما يدفع الولايات المتحدة
لاتخاذ إمَّا قرارات مُلزمة، أو الاتجاه نحو الحلول البديلة الضعيفة، وفي كل
حالاتها لم تكن الولايات المتحدة صارمةً يومًا تجاه إسرائيل، وهو ما يحذّر منه
كاتب المقالة في إنه يُظهر أميركا على أنها دولة انتهازية ومنافقة وضعيفة وغير
قادرة على تنفيذ نفوذها.
اتفق الرئيس الأميركي
جو بايدن مباشرة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن في
الأشهر التي تلت ذلك، تصاعدت الخلافات حول كيفية ممارسة هذا الحق. وأبدت إدارة
بايدن استياءها من الحملة العسكرية الإسرائيلية العشوائية في بعض الأحيان في غزة،
والقيود التي فرضتها على تدفق المساعدات الإنسانية، وفشلها في وقف بناء المستوطنات
اليهودية الجديدة وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإعطاء
الأولوية للحرب على حماس على المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن. كما شعرت الإدارة
الأميركية بالإحباط إزاء فشل إسرائيل الذريع في طرح إستراتيجية قابلة للتطبيق لحكم
قطاع غزة بعد إضعاف حماس، وهو إغفال متفاقم بسبب رفضها تقديم أي خطة لمعالجة رغبة
الفلسطينيين في الحكم الذاتي.
تتلقَّى إسرائيل 3.8
مليار دولار سنويًا على شكل مساعدات عسكرية أميركية، وتعدّ الولايات المتحدة
الداعم الأكبر لإسرائيل لعقود من الزمن. إلا أنها تتردد كثيرًا في مواجهة إسرائيل
علنًا بشأن قطاع غزة. ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على رفض نصائحها الخاصة في
الغالب، قررت إدارة بايدن الانفصال علنًا عن إسرائيل، ولكنها أيضًا حتى في هذه
الحالة، تصرفت تصرفات هامشية: فرضت عقوبات على عدد قليل من المستوطنين المتطرفين،
وأسقطت الغذاء على غزة عبر الإنزال الجوي، وبنت رصيفًا عائمًا على ساحل غزة لتسهيل
شحن المساعدات[1]، وخالفت التفضيلات الإسرائيلية في قرارين رمزيين إلى حد كبير
صادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوقفت الإدارة الأميركية في مايو/أيار،
بعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب، تسليم بعض القنابل الكبيرة المصنعة في الولايات
المتحدة لتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين[2]. وفي الشهر نفسه، هددت بوقف شحن
الأنظمة العسكرية الأخرى إذا شنت إسرائيل هجومًا شاملًا على مدينة رفح، آخر معاقل
حماس، على الرغم من أنها لم تنفذ هذا التهديد أبدًا لأنها اعتبرت هجمات إسرائيل
على المدينة أقل من شاملة. إذا كان النجاح يُعَد إقناع إسرائيل بتبني المسار الذي
تريده واشنطن، فإن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين
الأول سياسة فاشلة.
ليست التوترات مع إسرائيل
على مدى العام الماضي سوى مثال واحد على مأزق مستمر وغير ملحوظ في السياسة
الخارجية الأميركية: كيفية إدارة الخلافات مع الأصدقاء والحلفاء. في اثنتين من
أكبر الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة في العالم اليوم، أي الحروب في
أوكرانيا وقطاع غزة، فإن السؤال المطروح هو كيفية التعامل على أفضل وجه مع شريك
يعتمد على واشنطن ويقاوم نصائحها في بعض الأحيان. ردت إدارة بايدن في كلتا
الحالتين، ردودًا صامتة وغير منتظمة، وفي كثير من الأحيان دون تحقيق أي نتائج
ملموسة. ومن عجيب المفارقات أن الإدارة التي وضعت التحالفات الأميركية في مركز
سياستها الخارجية تجد صعوبة بالغة في إدارة الخلافات التي تنشأ في تلك التحالفات.
ولكي نكون منصفين، فإن
المشكلة تعود إلى ما قبل إدارة بايدن بوقت طويل. وهذا أمر متأصل في التحالفات،
سواء كانت قانونية أو فعلية، لأن حتى أقرب الأصدقاء لا يتشاركون نفس المصالح. طورت
الولايات المتحدة على مدى عقود عديدة دليلًا شاملًا لإدارة النزاعات مع الخصوم، مع
تكتيكات تشمل كل شيء من اتفاقيات الحد من التسليح والقمم الدبلوماسية إلى العقوبات
الاقتصادية وتغيير النظام والحرب. ولكن عندما يتعلق الأمر بالخلافات مع الأصدقاء، فإن
تفكير واشنطن أقل تطورًا بكثير. إن شبكة التحالفات الواسعة التي تمتلكها الولايات
المتحدة تمنحها ميزة كبيرة على الصين وروسيا، اللتين لا تمتلك أي منهما الكثير من
الحلفاء، إلا أن هذه الميزة غالبًا ما تكون عوائدها أقل من المتوقع.
والخبر السار هو أن
عقودًا من التاريخ تشير إلى أن بعض التكتيكات لإدارة النزاعات مع الأصدقاء
والحلفاء تعمل بشكل أفضل من غيرها. وينبغي لواشنطن أن تستفيد من خبرتها الواسعة،
سواء كانت جيدة أو سيئة، لمساعدتها على التفكير بشكل منهجي في مثل هذه الاختلافات
حتى تتمكن من منع ظهورها، أو، بشكل أكثر واقعية، التعامل معها بشكل أفضل عندما
تظهر. يتعين على الولايات المتحدة على وجه الخصوص أن تكون مستعدة للتصرف بشكل أكثر
استقلالية، وانتقاد سياسات أصدقائها علنيًا إذا اعتبرتها غير حكيمة، وتقديم سياسات
بديلة خاصة بها. لو فعلت واشنطن ذلك، فسوف تكون لديها فرصة أفضل لتحقيق ما قد يبدو
مستحيلًا: تجنب الانقطاع في علاقاتها القيمة وحماية مصالحها.
احتكاكٌ تاريخي
قد يتوقع المرء أن قوة
الولايات المتحدة تضمن لها امتثال حلفائها، وهذا ما يحدث في كثير من الأحيان، ولكن
في كثير من الأحيان الأخرى، لا تترجم قوتها إلى نفوذ. ويقاوم الحلفاء في بعض
الأحيان ببساطة تفضيلات الولايات المتحدة أو يتجاهلونها، ويستعدون لتحمل العواقب.
ويحاولون في أحيان أخرى الالتفاف على الإدارة، من خلال حشد الجهات الفاعلة المحلية
المتعاطفة، مثل الكونغرس ووسائل الإعلام والمانحين السياسيين، للضغط على البيت الأبيض
لتغيير مساره. كانت هذه هي الإستراتيجية التي استخدمتها الصين القومية، التي مارست
«جماعة الضغط الصينية» المزعومة نفوذًا هائلًا على واشنطن في وقت مبكر من الحرب
الباردة، كما تبنتها إسرائيل أيضًا. وثمة خيار آخر أمام الشركاء الأميركيين يتمثل
في تنويع داعميهم الدبلوماسية، وتقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة من خلال
إيجاد رعاة جدد. على سبيل المثال، اتجهت المملكة العربية السعودية وتركيا إلى
روسيا والصين بعد تدهور علاقاتهما مع الولايات المتحدة.
لماذا يجرؤ الحلفاء على
تحدّي واشنطن؟ لأن ما هو على المحك بالنسبة لهم عادة أكبر بكثير مما هو على المحك
بالنسبة للولايات المتحدة، وهو التفاوت الذي يمنحهم نفوذًا، على الرغم من اعتمادهم
عليها. تشكل نقطة الخلاف في كثير من الحالات القسم الأعظم من المصالح الأمنية أو
الاقتصادية للحليف، في حين أنها بالنسبة للولايات المتحدة ليست سوى واحدة من
أولويات عديدة، وبالتالي فإن احتمالات لجوء واشنطن إلى التدخل لحل النزاع أقل من
احتمالات لجوء الحليف إلى التدخل المباشر. وإذا ابتعدت واشنطن عن حليف، بغض النظر
عن مدى مبرر أفعالها، فإن بعض المنتقدين سوف يزعمون أنها لم تعد شريكًا موثوقًا
به، مما قد يدفع الحلفاء إلى التصرف دون أخذ المصالح الأميركية في الاعتبار،
ويشجّع الخصوم على تحديهم. تقيد مثل هذه الاعتبارات الولايات المتحدة.
وأصبح الاحتكاك،
جزئيًا، هو القاعدة وليس الاستثناء نتيجة لهذا عندما يتعلق الأمر بعلاقات الولايات
المتحدة مع الأصدقاء والحلفاء. اصطدمت الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية
الثانية مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي حول أفضل السبل لإدارة الحرب.
واختلفت مع الصين القومية حول إستراتيجيتها لهزيمة الشيوعيين خلال الحرب الأهلية
الصينية في أواخر الأربعينيات، ومع فرنسا وإسرائيل والمملكة المتحدة حول غزوهم
لمصر خلال أزمة قناة السويس عام 1956، ومع فرنسا حول هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي
في الخمسينيات والستينيات، ومع فيتنام الجنوبية في الستينيات وأوائل السبعينيات
حول الحكم والإستراتيجية العسكرية، ومع اليابان في الثمانينيات حول التجارة. كانت
واشنطن، منذ أكثر من 50 عامًا، على خلاف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي في أوروبا
بشأن الإنفاق الدفاعي. لم تتمكن الولايات المتحدة، خلال الفترة التي سبقت الغزو
الأميركي للعراق عام 2003، من حشد معظم حلفائها لدعم هذا التحرك.
ولعل باكستان تشكل
نموذجًا للصديق الصعب. على مدى العقود السبعة التي مرت منذ إنشائها في عام 1947،
ظلّت من أكبر المتلقين للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية. وساعدت الولايات
المتحدة خلال الحرب الباردة في احتواء الاتحاد السوفييتي، وسهلت الانفتاح
الدبلوماسي الأميركي على الصين. وبعد الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979، برزت
باعتبارها الشريك الرئيس للولايات المتحدة في تهريب الأسلحة إلى القوات المناهضة
للسوفييت هناك. ولكن العلاقة اتسمت في كثير من الأحيان بالخلافات المريرة بشأن
البرنامج النووي الباكستاني، وسجل باكستان السيئ في مجال حقوق الإنسان
والديمقراطية، ودعمها لطالبان والإرهاب، بما في ذلك إيوائها لأسامة بن لادن.
ونتيجة لهذا، نظرت باكستان إلى الولايات المتحدة باعتبارها صديقًا غير موثوق به ــ
وتنظر الولايات المتحدة إلى باكستان باعتبارها مشكلة أكثر منها شريكًا.
وتقدم تركيا مثالًا آخر
على العلاقة بين حلفاء ظاهريين بينهما الكثير من المشاكل. كانت تركيا من الدعامات
الأساسية لحلف شمال الأطلسي خلال الحرب الباردة، وعضوًا حاسمًا في التحالف الذي
انتشر ضد العراق خلال حرب الخليج. كما أنها اُعتبرت ذات يوم دليلًا على أن الدول
ذات الأغلبية المسلمة يمكن أن تكون مؤيدة للغرب، وديمقراطية، ومتقبلة لإسرائيل.
ولكن واشنطن وأنقرة اختلفتا أيضا بشأن الوجود العسكري التركي في قبرص، وحول
التزامها غير الكافي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي السنوات الأخيرة، حول
سياستها الخارجية الموالية لروسيا، والتمييز ضد الأكراد، والنزاعات مع إسرائيل.
عندما ننظر إلى هذا
التاريخ الطويل من النزاعات بين الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها، تبرز لنا
ستة تكتيكات متميزة نسبيَا لإدارتها. تنطوي بعض هذه التكتيكات تنطوي على التغريب،
وبعضها الآخر على الترهيب، وهناك تكتيكات أخرى تتقبل فكرة أن السلوك غير المرغوب
فيه للحليف لن يتغير ــ أو يمكن تغييره فقط إذا تغير نظامه. لا يوجد نهج يعمل في
جميع الحالات، ولكن بعض التكتيكات تعمل أفضل من بدائلها.
قوة الإقناع
الإقناع هو الأداة
الأساسية لإدارة التحالف. ومن الأمثلة الجيدة على هذا التكتيك الجهود التي بذلتها
الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمن لثني تايوان عن إعلان الاستقلال رسميًا.
فمن المؤكد أن مثل هذا الإعلان سيؤدي إلى تحرك عسكري صيني، ربما حصار أو غزو
للجزيرة، مما يجبر الولايات المتحدة على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستدافع عن
تايوان أم لا. إن أي رد فعل من جانب الولايات المتحدة، سواء كان بالفعل أو
بالامتناع عن الفعل، سوف يكون مكلفًا للغاية. أشارت الإدارات الأميركية المتعاقبة
إلى مقدار ما اكتسبته تايوان، برغم افتقارها إلى الاعتراف الدولي، فالجزيرة الآن
ديمقراطية نابضة بالحياة وذات اقتصاد مزدهر يتمتع بأكثر من نصف قرن من السلام،
وإلى مقدار ما قد تخسره إذا سعت إلى الاستقلال. وربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو
أن تايوان أصبحت تدرك أن الولايات المتحدة سوف تكون أقل ميلًا إلى التدخل نيابة
عنها إذا ما نظر إليها أنها هي التي أثارت أزمة.
والمثال الثاني الناجح
للإقناع يتعلق بإسرائيل. في يناير/كانون الثاني 1991، وفي الساعات الأولى من عملية
عاصفة الصحراء، الحملة العسكرية الأميركية لتحرير الكويت، أطلق الرئيس العراقي
السَّابق صدام حسين صواريخ سكود ضد إسرائيل لجرّها مباشرة إلى الحرب، وبالتالي دفع
الدول العربية إلى الانسحاب من التحالف الدولي الذي تشكل ضدّه. من المفهوم أن
القادة الإسرائيليين سعوا إلى ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس، ولكن الرئيس
الأميركي جورج بوش الأب أقنعهم بالتراجع، بحجة أن دخول إسرائيل إلى الحرب من شأنه
أن يعرض هدفًا أكثر أهمية بالنسبة لهم للخطر: هزيمة العراق. وتعهّد أيضًا بأن تقوم
الولايات المتحدة بتدمير مواقع الإطلاق العراقية. ورغم أن العلاقة بين بوش ونظيره
الإسرائيلي رئيس الوزراء إسحاق شامير كانت متوترة، فإن الحكومة الإسرائيلية اتخذت
القرار الصعب بالاستقالة.
ولكن بعض الجهود
الأميركية الأخيرة لكبح جماح إسرائيل، وفي مقدمتها محاولة كبح جماح حملتها
العسكرية في قطاع غزة، كانت نتائجها أسوأ بالتأكيد. وكانت دعوات إدارة بايدن لثني
إسرائيل عن تصعيد صراعها مع إيران ذات سجل أكثر تباينًا. في شنت إسرائيل في الأول
من أبريل/نيسان 2024 غارة جوية على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا، مما أسفر عن
مقتل عدد من كبار أعضاء في فيلق القدس الإيراني. ولم تتلق إدارة بايدن إلا تحذيرًا
ضئيلًا عن الهجوم، وكانت قلقة من أنه قد يؤدي إلى تحويل الصراع غير المباشر في
قطاع غزّة إلى مواجهةٍ أكثر مباشرة وخطورة. وبعد أسبوعين، ردت إيران بإطلاق سلسلة
من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل. وعلى الرغم من أن الهجوم الإيراني
لم يتسبب إلا في أضرار قليلة ولا تذكر، فقد نصحت إدارة بايدن إسرائيل نصحًا
مباشرًا بعدم الرد عسكريًا، خوفًا من فتح دورة تصعيدية. وقال بايدن لنتنياهو: «خذ
هذا الفوز»، مضيفًا أنه إذا صعَّدت إسرائيل، فستكون وحدها. ولكن إسرائيل لم تتراجع
عن موقفها، وردت بشكل محدود، حيث أطلقت عددًا قليلًا من الصواريخ من طائرات خارج
المجال الجوي الإيراني، ودمّرت بطارية دفاع جوي بالقرب من منشأة نطنز النووية
الإيرانية، والتزمت الصمت إلى حد كبير بشأن الهجوم الذي أعقب ذلك. باختصار،
استجابت إسرائيل إلى حد كبير للنصيحة الأميركية، وتمكّنت من تجنب أزمة أكبر.
الوصول إلى موافقة
الحلفاء والأصدقاء
قد تلجأ الولايات
المتحدة، عندما تفشل محاولات الإقناع وحدها، إلى الحوافز (الترغيب)، وهي أداة أخرى
من أدوات إدارة التحالف. إن أحد الأمثلة البارزة على الاستخدام الناجح للحوافز
يأتي من ثمانينيات القرن العشرين، عندما عارضت إسرائيل بيع الولايات المتحدة
طائرات مراقبة مزودة بنظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا«AWACS» إلى
المملكة العربية السعودية. كانت الولايات المتحدة تريد تلبية الرغبات السعودية، في
حين كانت إسرائيل قلقة حيال الحفاظ على تفوقها العسكري على الدول العربية، ومارست
ضغوطًا شديدة ضد الاتفاق. وقد بذلت إدارة ريغان جهودًا جاهدة للتغلب على معارضة
الكونغرس لها. وفي النهاية، تمَّ التوصل إلى حل وسط: المضي قدمًا في عملية البيع،
ولكن بشروط، بما في ذلك ضمان عدم نقل أي معلومات تجمعها عبر نظام الإنذار المبكر
والتحكم المحمول جوًا إلى أطراف ثالثة دون موافقة الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى تهدئة الحلفاء،
تُستخدم الحوافز لتشجيع السلوكيات التي قد لا تتحقق لولاها. قدَّمت الولايات
المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر لتعزيز الحكومة، حتى تتمكن من الحفاظ على
السلام مع إسرائيل. كما قدَّمت المساعدة إلى باكستان لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب،
والحفاظ على التعاون في أفغانستان، والحفاظ على بعض النفوذ على الأقل في السياسة
الداخلية والخارجية لإسلام أباد. كما قدمت المساعدة لتركيا لتعزيز ضبط النفس في
الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، والحد من
التوغلات الروسية.
أما العقوبات فهي عكس
الحوافز. ويُنظر عادة إلى هذه التدابير باعتبارها أسلحة تُستخدم ضد الخصوم، إلا
أنها استُخدمت أيضًا ضد الأصدقاء. مارست واشنطن في عام 1956 ضغوطًا مماثلة على
فرنسا وإسرائيل والمملكة المتحدة بعد غزوها مصر ومحاولتها الاستيلاء على قناة
السويس. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في أعقاب تدخلها في قبرص
واحتلالها لها عام 1974، وضد باكستان في عام 1990؛ بسبب برنامجها للأسلحة النووية،
وضد إسرائيل في عام 1981؛ بسبب قصفها لمفاعل أوزيراك النووي العراقي، وفي عام 1991
بسبب توطين اليهود السوفييت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد المملكة العربية
السعودية في عام 2021 بسبب مقتل المعارض (والمقيم الدائم في الولايات المتحدة)
جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في عام 2018.
وإذا كان الهدف هو
تعديل سلوك في الدولة المقصودة، فإن نتائج هذه العقوبات لم تكن جيدة عمومًا، وكان
الاستثناء الوحيد هو أزمة قناة السويس، عندما تراجعت فرنسا وإسرائيل والمملكة
المتحدة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الأميركية. ونجحت فقط لأنها وقعت في وقت كانت
فيه بريطانيا عُرضة بشكل خاص للضغوط الاقتصادية الأميركية (لم يكن الجنيه الإسترليني
قادرًا على الاحتفاظ بقيمته من دون دعم واشنطن)، وكانت فرنسا تعتمد اعتمادًا
كبيرًا على النفط في الشرق الأوسط، ولم تكن إسرائيل قد نجحت بعد في حشد قدر كبير
من الدعم السياسي في الولايات المتحدة. ولم يتمكن التهديد بالعقوبات ولا حقيقة
العقوبات من وقف البرنامج النووي الباكستاني. ويمكن قول الشيء نفسه عن العقوبات
التي تهدف إلى إنهاء احتلال تركيا لقبرص.
ولكن العقوبات قد تكون
ذات قيمة كأداة معيارية: فحتى لو فشلت في وقف النشاط غير المرغوب فيه، فإنها قد
تؤدي إلى زيادة التكاليف على الصديق والإشارة إلى استياء الولايات المتحدة، وإرسال
رسالة أوسع إلى الأصدقاء الآخرين حول تفضيلات الولايات المتحدة. ومن الأمثلة على
ذلك سياسة إدارة جورج بوش الأب تجاه إسرائيل في عام 1991. وكانت الإدارة الأميركية
قد بذلت جهودًا كبيرة للضغط على الاتحاد السوفييتي للسماح لليهود بالهجرة، وكانت تسعى
إلى عقد مؤتمر سلام إقليمي بعد حرب الخليج. وكان ما فعلته الحكومة الإسرائيلية
مثيرًا للغضب والإحباط، حيث وضعت إعانات وسياسات أخرى لتحفيز هؤلاء اللاجئين على
العيش في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة وأنّ الحكومة
الإسرائيلية كانت قد طلبت من الولايات المتحدة ضمان 10 مليارات دولار في شكل قروض
تهدف إلى تسهيل انتقالهم. حاولت إدارة بوش إقناع الحكومة الإسرائيلية بإنهاء
السياسات المصممة لتوجيه اليهود السوفييت إلى المستوطنات، وعندما فشلت تلك
المحاولة، قلَّصت حجم القروض التي ستضمنها، مما دل على أن تجاهل التوسلات
الأميركية سوف يكون له ثمن باهظ.
إن الأسلوب الأكثر قسوة
في التعامل مع الخلاف مع صديق هو السعي إلى الإطاحة بالحكومة المخالفة. وكان هذا
هو النهج الذي اتبعته إدارة كينيدي مع حليفها الفيتنامي الجنوبي المثير للمتاعب،
الرئيس نغو دينه ديم (Ngô Đình Diệm). بذلت الإدارة الأميركية وقتها جهودًا
كثيرة لتعزيز الآفاق السياسية للرئيس ديم، ولكنها سرعان ما أصيبت بخيبة الأمل إزاء
قيادته الفاسدة وغير الفعَّالة، حيث نظرت إليه باعتباره عبئًا في الصراع ضد فيتنام
الشمالية والفيت كونغ. وبلغت الأمر مبلغه في صيف عام 1963 عندما أوضح المسؤولون
الأميركيون في سايغون أنهم ورؤساءهم في واشنطن سوف ينظرون بعين العطف إلى الانقلاب
الذي يقوده كبار الضباط العسكريين. وبحلول الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن
ديم قد أصبح خارج السلطة فحسب، بل ميتًا أيضًا، حيث قُتل على يد الجنود الذين أطاحوا
به. ولكن قرار إدارة كينيدي لم يحقق التأثير المطلوب: فقد أثبت خلفاء ديم أنهم غير
قادرين على كسب تأييد الشعب الفيتنامي وهزيمة الشمال. ولكن ما فعله الانقلاب هو
ربط الولايات المتحدة بشكل أوثق بحكومة فيتنام الجنوبية ومصيرها.
وثمة جهد أحدث، وأكثر
تواضعًا إلى حد كبير، لتغيير النظام الإسرائيلي في عام 2024. كان تشاك شومر، زعيم
الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو ديمقراطي من نيويورك، وربما السياسي اليهودي الأكثر
شهرة في الولايات المتحدة، قد شعر بالإحباط إزاء افتقار إسرائيل الواضح إلى
الاهتمام بأرواح المدنيين في غزة. فألقى في 14 مارس/آذار، خطابًا من قاعة مجلس
الشيوخ انتقد فيه نتنياهو بسبب ارتفاع عدد القتلى ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة
في إسرائيل على افتراض أن من شأن التغيير في القيادة أن يتُرجم إلى تغيير في
السياسة. وقد أشارت دعوته إلى استياء أحد أشد المؤيدين لإسرائيل، لكنها فشلت في
إحداث أي تغيير في قيادة الدولة أو سياستها. والأسوأ من ذلك أن هذا القرار كان له
تأثير عكسي تمثل في السماح لنتنياهو بالتفاخر بعباءة قومية تصوره مدافعًا عن
إسرائيل ضد التدخل الخارجي.
غضّ الطرف عن أخطاء
الحُلفاء والأصدقاء
ويوجد خيار آخر للتعامل
مع الحليف المزعج وهو خيارٌ أكثر سلبية: النظر في الاتجاه الآخر. فبدلًا من إثارة
مشكلة؛ بسبب خلاف مع صديق، يمكن لواشنطن أن تتجاهل التجاوز، مدركة أن محاولات
تغيير سلوك الشريك ستكون مكلفة للغاية أو محكوم عليها بالفشل. يعتبر هذا بمثابة
تجنب دبلوماسي.
ومرة أخرى، تقدم
إسرائيل مثالًا جيدًا لهذا النهج العملي. قررت إسرائيل في الخمسينيات والستينيات
من القرن العشرين أنها بحاجة إلى ترسانة نووية لمواجهة المزايا العسكرية التقليدية
الهائلة التي يتمتع بها أعداؤها العرب، الذين رفضوا قبول وجودها. عارضت الولايات
المتحدة البرنامج النووي الإسرائيلي بشدة، الذي يشكل انتهاكًا لالتزامها بمنع
الانتشار النووي. ولكن مع مرور الوقت قررت واشنطن عدم إثارة خلاف كبيرٍ حول
الموضوع، وخلُصت إلى أنها ربما لن تتمكن أبدا من إقناع إسرائيل بالتخلي عن سعيها
للحصول على القنبلة النووية. كانت لدى الولايات المتحدة أولويات أخرى أكثر أهمية
خلال الحرب الباردة في الشرق الأوسط، والتي كانت تتطلب التعاون مع إسرائيل، وكانت
لديها أدوات أخرى (بما في ذلك المساعدات العسكرية والضمانات النووية) التي يمكن أن
تمنع الأصدقاء الآخرين في المنطقة من السعي إلى امتلاك أسلحة نووية. وربما تصور
المسؤولون أيضًا أن إسرائيل النووية قد تقنع الحكومات العربية بأن الدولة اليهودية
موجودة في المنطقة لتبقى، مما يمهّد الطريق في هذه العملية للقبول وحتى محادثات
السلام. لقد أصبح تجاهل الأمر أسهل بسبب قرار إسرائيل بعدم الاعتراف رسميًا
بترسانتها النووية وتجنب إجراء الاختبارات الواضحة. وبعد مرور أكثر من نصف قرن من
الزمان، يبدو أن هذه السياسة أثبتت صحتها: فهناك سلام بين إسرائيل والعديد من
جيرانها، ولم يسبق لأي دولة أخرى في المنطقة أن اتبعت خطى إسرائيل، وتحولت إلى
امتلاك الأسلحة النووية.
ولكن عندما يتعلق الأمر
بالأنشطة الإسرائيلية الأخرى، فقد ثبت أن التجنّب الدبلوماسي أكثر تكلفة بكثير من
الفعل. فبعد انتصارها في حرب الأيام الستة عام 1967، قامت إسرائيل ببناء
المستوطنات في جميع الأراضي التي استولت عليها في الحرب: مرتفعات الجولان والضفة
الغربية وقطاع غزّة وسيناء. واعتبرت أغلب الإدارات الأميركية هذه المستوطنات
عائقًا أمام أي تبادل مستقبلي للأراضي مقابل السلام. ومع ذلك، لم يطالب أي رئيس
أميركي (باستثناء جزئي لجورج بوش الأب) إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع
المستوطنات، وهددها بفرض عقوبات إذا لم تفعل ذلك. ولم يكن المسؤولون الأميركيون
مهتمين بالدخول في معركة سياسية مع إسرائيل وأنصارها الأميركيين في ظل غياب اتفاق
واعد بين إسرائيل والفلسطينيين. وليس من المستغرب أن يرتفع عدد المستوطنات
والمستوطنين ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمسين الماضية. وكما كان متوقعًا، حتى
قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صارَ إنشاء دولة فلسطينية أمرَا أصعب كثيرًا في
إسرائيل، لأن المستوطنين يشكّلون دائرة انتخابية قوية، وبين الفلسطينيين، الذين
أصبحوا أكثر تشككًا في أن السلام من شأنه أن يمنحهم السيطرة على أراض كبيرة
ومتجاورة.
كما غضت الولايات المتحدة
الطرف عن أوكرانيا أيضًا. وقد شكّك العديد من المسؤولين الأميركيين في حكمة قرار
أوكرانيا بشن هجوم مضاد كبير في عام 2023، وخشوا أن هذا القرار لن يفشل فحسب، بل
سيؤدي أيضًا إلى تحويل الموارد الثمينة بعيدًا عن مهمة الدفاع عن الأراضي التي
تسيطر عليها أوكرانيا بالفعل. ويخشى آخرون من أن نجاح الهجوم المضاد قد يدفع روسيا
إلى استخدام الأسلحة النووية، أو على الأقل التهديد باستخدامها. وكانت الإدارة
مترددة أيضًا في الضغط من أجل أي مبادرة دبلوماسية من شأنها أن تدفع أوكرانيا إلى
التنازل عن هدفها المتمثل في استعادة كل أراضيها التي فقدتها منذ عام 2014. لكن
الحكومة الأميركية لم تكن راغبة في مواجهة أوكرانيا، خشية أن يبدو الأمر وكأنها لا
تبذل جهودًا كافية لصالح صديق محاصر يقاوم العدوان.
كان التجنب له نتائج
عكسية في هذه الحالة. وكما كان متوقعًا، فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في
عام 2023 في تحقيق اختراق حاسم، بينما استنفد ذخيرة ومعدات ثمينة، وأدى إلى خسارة
العديد من الأرواح. وقد أعطى هذا الفشل أيضًا حجة لأعضاء الكونغرس الذين عارضوا تقديم
المساعدات لأوكرانيا، مما جعل من السهل عليهم الادعاء بأن المساعدة لم تكن مرتبطة
بسياسة لديها فرصة للنجاح. وكان من الأفضل لإدارة بايدن أن تضغط على أوكرانيا
لتبني إستراتيجية دفاعية بمجرد استقرار ساحة المعركة في منتصف عام 2022 والإشارة
إلى الترتيبات الإقليمية التي قد تكون مستعدة لقبولها في مقابل وقف إطلاق النار
المؤقت. وكان من شأن هذا النهج أن يحافظ على القوى البشرية والموارد في الدولة،
وكان من شأنه أن يقنع روسيا بأن أي قدر من الجهود الهجومية من جانبها لن ينجح.
واتّبعت الولايات
المتحدة نهجًا تجنبيًا تجاه الهند أيضًا. أعطت الإدارات الديمقراطية والجمهورية
على حد سواء، في السنوات الأخيرة، الأولوية للعلاقة بين الولايات المتحدة وأكبر
دولة من حيث عدد السكان في العالم بهدف التصدي للصين، وتوسيع التجارة الثنائية
والاستثمار، وإقامة وتثبيت حسن النية بين المجتمع الهندي الأميركي النشط سياسيًا.
ولكن هذه الإستراتيجية تطلبت التغاضي عن النزعة غير الليبرالية المتنامية في الهند
في الداخل، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ترتكبها في الخارج، واستمرار
علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع روسيا، مما جعل الولايات المتحدة تبدو أكثر
انتهازية من كونها مبدئية. ومع مرور الوقت، فإن تجاهل هذه الحقيقة يأتي محفوفًا
بالمخاطر، ذلك أن الهند التي تصبح أقل تفانيًا في تراثها العلماني قد تصبح أكثر
تفككًا وأقل استقرارًا. كما أن نهج واشنطن الذي يُفضل التجنب يزيد من احتمال
استمرار الهند في التحوط في سياستها الخارجية وتظل شريكًا غير موثوق به تمامُا
للولايات المتحدة.
الحل البديل: التحرّك
المُستقل
إذا فشلت كل الطرق
الأخرى، أو اعتُبرت مكلفة للغاية، يتبقى خيار قوي واحد للتعامل مع الخلاف مع
الحليف: التحرّك المستقل. وبدلًا من محاولة دفع دولة أخرى إلى تغيير سلوكها،
تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل على تجاوز تلك الدولة، وتروج للمصالح الأميركية
بالشكل الذي تراه مناسبًا.
لجأت إدارة بايدن بسبب
إحباطها من الحملة العسكرية في قطاع غزّة إلى استخدام هذا التكتيك ضد إسرائيل. في
فبراير/شباط 2024، وبعد استخدام حق النقض ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة اعتبرتها غير عادلة لإسرائيل، قدمت الولايات المتحدة، على الرغم من
احتجاجات إسرائيل، اقتراحها الخاص الذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار. وسرعان ما
استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد الاقتراح؛ لأنه يدعم المخاوف الإسرائيلية بشكل
مفرط، ولكن في الشهر التالي، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار آخر
طلبت إسرائيل منها نقضه. وفي الوقت نفسه، تصرفت إدارة بايدن أيضًا بشكل أحادي
الجانب في قطاع غزّة، حيث قامت بإسقاط الغذاء من الجو وبناء رصيف عائم على ساحل
البحر الأبيض المتوسط للتحايل على القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات
الإنسانية. وفي شهر مايو/أيار، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على توريد قنابل تزن
500 و2000 رطل، والتي يمكن أن تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع[3]. وكان
تأثير كل هذا التحرك المستقل متواضعًا: فقد فشل في فعل الكثير للحد من شدة الأزمة
الإنسانية، ولكنه أشار إلى أن إسرائيل لا تملك حق النقض على السياسة الأميركية.
وهناك مثال آخر حدث
مؤخرا يتعلق بأوكرانيا، حيث رفضت إدارة بايدن في عامي 2022 و2023 تزويد كييف
بالطائرات والصواريخ بعيدة المدى والذخائر العنقودية. ولم تكن هذه السياسة بمثابة
عقوبة، لأنها لم تكن عقوبة مفروضة ردًا على أي شيء يُعتبر غير منتج. ولكن الأمر لم
يكن كذلك، بل كان قرارًا أحادي الجانب بوقف الأسلحة، وهو ما اعتقدت واشنطن أنه لن
يكون فعالًا بدرجة كافية وربما يؤدي إلى تصعيد الوضع.
ولعل المثال الأكثر
دراماتيكية على التحرّك المستقل كان الغارة العسكرية الأميركية في مايو/أيار 2011
التي قتلت أسامة بن لادن الذي كان يختبئ في مجمّع قريب من الأكاديمية العسكرية
الباكستانية. وبافتراض أن بعض كبار المسؤولين الباكستانيين على الأقل كانوا على
علم بوجوده هناك وتعاطفوا معه، قررت إدارة أوباما عدم تحذير باكستان بشأن الغارة.
وحلقت القوات الأميركية بدون إذن، منتهكة بذلك سيادة دولة صديقة، في مهمة أثبتت
نجاحها. استنتج المسؤولون الأميركيون بحق أن المخاطر كانت عالية للغاية بحيث لا
يجوز تعريض العملية للخطر من خلال إخطار الحكومة الباكستانية، وعلى أي حال فإن
العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان كانت بالفعل متوترة إلى الحد الذي يجعل
التأثير الهامشي لهذه الجريمة على الأرجح ضئيلًا.
ومع ذلك، فإن التحرّك
المستقل قد يحقق نتائج سلبية غير متوقعة. ولنأخذ في الاعتبار السياسة الأميركية
الأخيرة في أفغانستان. في فبراير/شباط 2020، عندما لم تر إدارة ترامب أي طريق
لتحقيق النصر العسكري أو السلام التفاوضي بعد عقدين من الحرب، وقَّعت اتفاقًا مع
طالبان من وراء ظهر الحكومة الأفغانية لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في
أفغانستان. أدى الاتفاق إلى تقليص الوجود الأميركي، ولكن بتكلفة هائلة: فقد أدى
إلى تقويض الحكومة الأفغانية وإضعافها، مما مهد الطريق أمام طالبان لاستعادة
السيطرة على أفغانستان بعد 18 شهرًا، عندما استولت طالبان على كابول مع انهيار
الحكومة الأفغانية. كان بوسع إدارة بايدن التراجع عن الاتفاق مع طالبان، وكانت
هناك فرصة جيدة لبقاء الحكومة الأفغانية على قيد الحياة لو حافظت واشنطن على
وجودها الخفيف نسبيًا المتمثل في عدة آلاف من الأفراد غير المقاتلين. لم تكن تعد
مثل هذه السياسة بالسلام ولا بالنصر، ولكن بالمقارنة مع ما حدث، فمن المرجح أنها
كانت لتكون أفضل بكثير بالنسبة لشعب أفغانستان، وبالنسبة لسمعة الولايات المتحدة.
عندما يختلف الأصدقاء
إن الكثير من السياسة
الأميركية تجاه الحلفاء مبني على افتراض أن الاتفاق هو القاعدة والاختلاف هو
الاستثناء. يعتقد صناع السياسات ضمنًا أن إيجاد أرضية مشتركة ينبغي أن يكون ممكنًا
في كل الأحوال تقريبًا، نظرًا لمدى اعتماد حلفاء الولايات المتحدة عليهم ومدى
سهولة استفادة واشنطن من مواردها الكبيرة لمعاقبتهم أو دعمهم. لكن هذه الثقة في
غير محلها. تشكل الخلافات مع الأصدقاء سمة منتظمة للسياسة الخارجية الأميركية، وهي
سمة لا يمكن التخلص منها.
الخطوة الأولى لمعالجة
المشكلة مباشرةً هي فهم الأساليب التي تنجح والتي لا تنجح، ومتى تنجح. قد يكون
الإقناع صعبًا أو مستحيلًا عندما يرى الصديق أن مصالحه الأساسية على المحك. ومع
ذلك، فإن الحوار الإستراتيجي الحقيقي حول القضايا الأكثر حساسية، إذا تم بشكل خاص
وقبل اتخاذ القرار بشأن السياسة، يمكن أن يمنع الأزمات والمفاجآت في العلاقة. وحتى
لو فشلت الجهود، فمن الممكن الاستشهاد بها لتبرير القرار بالتحول إلى أساليب أخرى.
ماذا قد يعني هذا
عمليًا؟ وفيما يتصل بإسرائيل، يتعين على واشنطن أن تطرح أفكارها بشأن الاستجابات
الدبلوماسية والعسكرية للبرنامج النووي الإيراني وحزب الله، فضلًا عما تريده من
إسرائيل فيما يتصل بالفلسطينيين والسلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. وينبغي
للاتحاد الأوروبي أيضًا أن يعقد مناقشات صادقة، وإن كانت صعبة، مع أوكرانيا، وأن
يدافع عن التوجه العسكري الدفاعي إلى حد كبير والمبادرة الدبلوماسية التي تعكس
الحقائق على الأرض.
ومن الطبيعي أن تعمل
الحوافز على جعل الإقناع أكثر فعالية، ويبدو أن هذه الأداة تعمل مع المملكة
العربية السعودية: إذ تدرس الرياض تطبيع علاقاتها مع إسرائيل والحد من علاقاتها مع
الصين في مقابل اتفاقية أمنية أميركية ومساعدة نووية مدنية. وفيما يتصل بأوكرانيا،
يمكن للولايات المتحدة أن تتعهد بتخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة
الأميركية وتقديم مساعدات عسكرية طويلة الأجل وضمانات أمنية، وكل هذا لإقناع كييف
بتبني إستراتيجية عسكرية أكثر دفاعية وإعلان استعدادها من حيث المبدأ لقبول وقف
مؤقت لإطلاق النار. ولكن في حالة تايوان، قد تتمكن الولايات من الوعد بشكل أكثر
صراحة بالتدخل لإنقاذها في حالة حدوث غزو صيني (وهي السياسة المعروفة أحيانًا باسم
«الوضوح الإستراتيجي»)، مع توضيح أن تايبيه بحاجة إلى ممارسة ضبط النفس في القضايا
عبر مضيق تايوان والاستثمار بشكل أكبر في دفاعاتها. ومع إسرائيل، قد توافق
الولايات المتحدة على دعم خطة الاستقرار في قطاع غزّة أو تعويض تكاليف أي اتفاق
سلام مع الفلسطينيين، وتقديم مساعدات عسكرية إضافية لمواجهة أي تهديدات متزايدة
ناجمة عن فقدان الأراضي، والمساعدة الاقتصادية لتعويض أولئك الذين سيُطلب منهم
إخلاء المستوطنات.
لا يبعث سجل العقوبات
بالتفاؤل من فاعليها، وعندما تستخدم ضد الأصدقاء، فإنها تكون أكثر فعالية في
الإشارة إلى استياء الولايات المتحدة من استخدامها لتغيير السلوك. وإذا استمر
السلوك المخالف بعد فرض العقوبات، فمع مرور الوقت، تصبح الاعتبارات الأخرى لها
الأسبقية، وتخفّف التدابير أو تُزال تمامًا، مما يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة
ومنافقة. وكقاعدة عامة، قبل فرض عقوبات على صديق، ينبغي لواشنطن أن تدرس ما إذا
كانت تريد الإبقاء على هذه العقوبة، نظرًا لأن مصالح أخرى سوف تتدخل حتمًا. وإذا
قررت الذهاب في هذا الطريق، فينبغي أن تكون العقوبات محددة بدقة.
إن رد فعل إدارة بايدن
على مقتل خاشقجي هو مثال على الأمر أعلاه. وكان من المتوقع تمامًا أن تأخذ
العلاقات مع المملكة العربية السعودية في الاعتبار إيران وإسرائيل والحرب في اليمن
وأسعار النفط والصين، وهي العوامل التي جعلت من غير الممكن التعامل مع المملكة
باعتبارها دولة منبوذة. ولكن بعد ذلك، تصرفت الإدارة بحكمة وقررت تغيير موقفها.
لقد أظهرت الولايات المتحدة استياءها مما حدث والتزامها بالمبادئ (وهو ما لم تفعله
إدارة ترامب) من خلال الإعلان عن تحقيق وكالة المخابرات المركزية في جريمة القتل
وفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين السعوديين الذين لم يكونوا محوريين في عمل
العلاقة. ولكنها لم تتضمن عقوبات أو شروطًا من شأنها أن تجعل التعاون مستحيلًا.
ينبغي تجنب الأداة
الأكثر قسوة، أي تغيير النظام. ومن غير المرجح أن تسفر هذه التغييرات عن ظهور
قيادة جديدة، وحتى لو حدث ذلك، فليس هناك ما يضمن أن النظام الجديد سيكون أفضل
دائمًا. تعد هندسة العمليات الداخلية لدولة أخرى من أصعب الأمور في السياسة
الخارجية. وستؤدّي محاولة القيام بذلك مع حليف إلى نتائج عكسية، مما يحول التركيز
عن الخلافات الجوهرية، ويمنح الهدف بطاقة قومية للعبها [كما فعل نتنياهو]، ويثير
أسئلة غير مريحة في عواصم حليفة أخرى.
قد يكون غضّ الطرف
منطقيًا عندما يكون من المستحيل تقريبًا التأثير على سلوك الصديق أو عندما تكون
هناك مصالح أخرى كبيرة على المحك مما يجعل المواجهة مستحيلة. ولكن هذا التكتيك لا
معنى له عندما تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير أو عندما تكون تكاليف تجاهل
المشكلة باهظة.
إن الإقناع الترغيب
والترهيب والعقوبات وغض الطرف لها شيء مشترك: فهي جميعها تترك المبادرة للصديق أو
للحليف، وهو ما يفسر عدم فاعليتها. الخيار الوحيد الذي يُعطي السيطرة للولايات
المتحدة هو التحرك المستقل. قد يكون التحرك المستقل وتجاوز الحليف جذّابًا عندما
تفشل الخيارات الأخرى أو تستبعد، وتكون المصالح الأميركية ما تزال تتطلب القيام
بفعلٍ ما.
وفيما يتعلق بإسرائيل،
يمكن لإدارة بايدن البناء على الحلول البديلة الحالية والذهاب إلى أبعد من ذلك
بكثير. على سبيل المثال، يمكن لمشروع قانونِ أن يتطلب وضع علامة على السلع المصنعة
في المستوطنات الإسرائيلية تشير إلى أنها من أصل الأراضي المحتلة بدلًا من «صنع في
إسرائيل»، وهو ما يعيد السياسة التي عكستها إدارة ترامب. يمكن للولايات المتحدة أن
تتوقف عن تجميل اعتراضها على المستوطنات، وتصفها بأنها «غير قانونية» بدلًا من
مجرد «عقبات أمام السلام» أو «تتعارض مع القانون الدولي»، وتدعم قرار مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة الذي ينص على ذلك. ويمكنها أن تبذل المزيد من الجهود لإصلاح
وتعزيز السلطة الفلسطينية. ويمكنها أن تعلن علنًا وتدفع باتجاه تحقيق رؤيتها بشأن
الحكم في قطاع غزّة وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على نطاق أوسع.
وعلى نحو مماثل، تستطيع
الولايات المتحدة أن تشترط في أوكرانيا ألا تستخدم أي من الأسلحة التي تقدمها لشن
هجوم مضاد جديد، وأن تستمر المساعدات العسكرية فقط إذا التزمت أوكرانيا بقبول وقف
إطلاق النار المؤقت على أساس التقسيم الإقليمي الحالي. (ولنكن واضحين، لن تضطر
أوكرانيا إلى التخلي عن مطالباتها الإقليمية، أو قدرتها على إعادة التسلح، أو خيار
الانضمام إلى تحالفات كشرط للمساعدات). ولن تكون النتيجة هي السلام، ولكن كما
أوضحت تجربة شبه الجزيرة الكورية، فإن الهدنة يمكن أن توقف الحرب على الأقل.
وينبغي أن يتضمن التحرك
المستقل أيضًا الاستعداد لانتقاد السلوكيات علنًا أو حتى الانضمام إلى المناقشات
السياسية المحلية في البلدان الأخرى. لقد موَّل وحرَّض زعماء إسرائيل وأوكرانيا
وتايوان جميعًا المشرعين ووسائل الإعلام، وينبغي لرؤساء الولايات المتحدة أن
يتعلموا من طريقة تعاملهم وأن يفعلوا الأمر نفسه. تحدث نتنياهو في عام 2015 أمام
الكونغرس للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة أوباما، وفي
يونيو/حزيران 2024، سجل مقطع فيديو يتهم فيه إدارة بايدن زورًا بتهديد أمن إسرائيل
من خلال حجب الأسلحة والذخيرة. كان ينبغي لأوباما أن يطلب وقتًا متساويًا في
الكنيست للحديث عن حجته بشأن الاتفاق النووي ومصلحته للشعب الإسرائيلي، وكان ينبغي
لبايدن أن يتوجه إلى غرفة الإحاطة في البيت الأبيض، ويطالب نتنياهو بالاعتذار عن
تحريف الحقائق. في مثل هذه المواقف، ما هو مطلوب هو الحب القاسي، أو على الأقل
حبًّا أكثر صرامة.
ليس التحرك العمل حلًا
سحريًا، لأنه لا يوقف السلوك المسيء، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى تراجع الشريك.
إلا أنه يسمح للولايات المتحدة بحماية نفسها من بعض العواقب السلبية وتعويضها. كما
أن ذلك يساعد على الحفاظ على العلاقة مع الصديق وتذكيره بأن الولايات المتحدة
لديها خيارات خاصة بها. وعلى المدى الطويل، قد يوضح هذا التكتيك التكاليف المترتبة
على عدم أخذ تفضيلات الولايات المتحدة ومصالحها في الاعتبار. وهذا، بعد كل شيء،
ينبغي أن يكون محور أي إستراتيجية أميركية تجاه حليف لا تتفق معه: متابعة مصالحها
دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لعلاقة قيمة.